يقول إدغار موران في كتابه "مفهوم الأزمة" إن أزمة مجتمع ما تحفز مسارين متناقضين، يتمثل الأول في البحث عن حلول جديدة تحفز الخيال والإبداع، أما المسار الثاني فيتمثل في البحث عن الخلاص بالعودة إلى ماض كان مستقرا وبالتعلق بمنقذ قدري مع إدانة أو حرق مذنب ما يفترض أنه كان بأخطائه، سببا في ظهور الأزمة أو أنه مجرد مذنب خيالي، أي كبش فداء يجب التخلص منه. وفي ظل الأزمة يسود نوع من اللايقين يخص بنية وشكل النظام مستقبلا متأثرا بتراجع الحتميات والتوقعات.
ينطبق جزء كبير من هذا التوصيف على أمريكا منذ أن أعلن دونالد ترامب ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة ورفعه شعار "أمريكا أولاً"، ليعبّر من جهة عن نية واضحة لإعادة تشكيل العلاقة الاقتصادية لواشنطن مع بقية دول العالم ومن جهة أخرى إحداث تغييرات عميقة في النظام السياسي الأمريكي. ومع توليه الحكم، لم يكن هذا الشعار مجرد دعاية انتخابية، بل تحوّل إلى سياسة اقتصادية هجومية قائمة على إعادة التفاوض، فرض الرسوم، والانسحاب من بعض الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف. إلا أن المثير للجدل، أن هذه السياسات تجاوزت حدود الدفاع عن الاقتصاد الوطني لتُشعل فتيل حرب تجارية غير تقليدية، قلبت موازين التجارة العالمية، وأربكت النظام الاقتصادي الدولي برمّته.
بدأت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من الصين، بحجة حماية الصناعة المحلية الأمريكية من المنافسة غير العادلة. لكن هذه الرسوم كانت البداية فقط. فقد تتابعت قرارات مشابهة طالت حلفاء تقليديين للولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. هذا التحوّل في النهج الأميركي لم يقتصر على السياسة الاقتصادية، بل مسّ بجوهر النظام العالمي الليبرالي القائم على العولمة والذي كانت الولايات المتحدة من أبرز مهندسيه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي يقوم على مبادئ حرية التجارة والتكامل الاقتصادي، لنشهد اليوم انقلابا في الأدوار حيث تحولت الصين الشيوعية هي حاملة لواء الدفاع عن العولمة بينما تغرق الولايات المتحدة في سياسات حمائية تهز أسسها.
ما زاد من خطورة المشهد، هو تدخل ترامب المباشر في السياسات النقدية، عبر الضغط العلني على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بما يتعارض مع مبدأ استقلالية البنك المركزي الأميركي. هذا التدخل يشكل تهديداً حقيقياً لتوازن السلطات داخل الدولة الأميركية، ويمثل سابقة خطيرة تتجاوز قواعد الدستور الأميركي ذاته، الذي يفصل بين السلطات التنفيذية والنقدية حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وقد ساهمت تهديدات ترامب بإقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته التي تمتد إلى عام 2026، في إنهيار الأسواق المالية الأمريكية بينما أدى تراجعه عن نية الإقالة إلى إنتعاش الأسواق وعودة الأمل بحدوث إنفراج في الأزمة، وهذه حالة من حالات اللايقين التي تطبع سياسات واختيارات ترامب.
ورغم أن هذه السياسات تبدو متسرعة ومثيرة للجدل، إلا أن من المهم الاعتراف بأن خلفياتها ليست بلا منطق. فترامب، وإن كان يعالج الأزمة بشكل صدامي، إلا أنه يسلط الضوء على قضية جوهرية لطالما تم التغاضي عنها من قبل الإدارات الأميركية السابقة، وهي الصعود المتسارع للصين كقوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية تنافس الولايات المتحدة في عقر دارها. فقد استفادت الصين لعقود من نظام تجاري عالمي مفتوح، ونجحت في توظيفه لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، بل وحتى العسكرية، في ظل غفلة أو تساهل أو حتى دعم من واشنطن.
المعضلة أن الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم في موقع رد الفعل المتأخر، أمام خصم استراتيجي نجح في تقليص الفجوة التكنولوجية والصناعية والعسكرية، واستفاد من انفتاح الأسواق الغربية دون أن يفتح أسواقه بالقدر ذاته. لذا فإن قرارات ترامب، وإن كانت غير تقليدية وصادمة، فإنها في جزء منها محاولة لوقف هذا التدهور، ولو جاءت متأخرة.
لكن ما يُخشى منه هو أن تؤدي هذه السياسات إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن تُضعف ثقة المستثمرين في استقرار النظام الأميركي، وتدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود أعمق، في ظل التشابك الكبير بين الاقتصادات العالمية، وقد لاحظنا ذلك قبل أيام في نكسة سوق السندات في سابقة خطيرة. كما أن خروج الولايات المتحدة من اتفاقيات دولية، وشنها لحروب تجارية بشكل أحادي، قد يُفقدها الدور القيادي الذي لطالما تميزت به، ويفتح المجال لقوى أخرى – كالصين وروسيا – لإعادة تشكيل النظام العالمي وفق مصالحها.
في النهاية، يمكن القول إن ترامب يمثل مرحلة انتقالية في السياسة الأميركية، عنوانها القطيعة مع نهج التوافق والتحالفات، لصالح الانكفاء على الذات. لكن ما لم يتم التفكير في حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الواقع العالمي الجديد، فإن هذه السياسات قد تتحول من أدوات إصلاح إلى بذور لانقسام عالمي جديد، تعجز أمريكا لاحقاً عن التحكم بمآلاته.



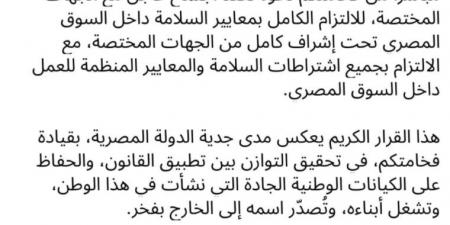
0 تعليق